
محنة الثقافة العربية
14 د.ا 4 د.ا
إن نقد الثقافة العربية التي رضع حليبها كل عربي ليس أمراً سهلاً، لأن كثير من العرب يعتبرون نقد ما يؤمنون به من آراء، وما يذهبون إليه من أقوال بمنزلة الإهانة لذواتهم وعقولهم، وأحياناً خيانة لتراث الأمة العربية وتاريخها. ولذا، حين كثرت الاتهامات لأقوالي وآرائي، وجدت نفسي مضطراً للوقوف عند بعضها، والرد عليها
بدأتُ في سبعينات القرن العشرين كتابة مقال أسبوعي بشكل منتظم، وكنت حينئذ أستاذاً في جامعة الكويت. ولما كانت عملية التنمية هي إحدى أهم القضايا التي انشغلتُ بها وقمت بتدريسها في الجامعة، فإنني خصصتُ جزءاً كبيراً من كتاباتي الصحفية لنقد الثقافة العربية، موضحاً أن الدور الذي تلعبه في الجانب الاقتصادي والسياسي من حياة المجتمع العربي يتصف عموماً بالسلبية، ما يجعلها بحاجة ماسة إلى التطوير. إلا أن الكثير من القراء انزعجوا مما ذهبت إليه من آراء، كما انزعج بعض زملائي في الجامعةً، لأنهم كانوا على قناعة في تلك الأيام بأن ثقافتهم هي أفضل الثقافات؛ وهذا يعني عندهم أنه لا يجوز نقدها، ولا ردها. ولما كانت تربية العقل العربي تدفعه إلى رؤية كل نقد للثقافة العربية ذماً لها، ومدحاً للثقافة الغربية، فإن أغلبية الردود والتعليقات على مقالاتي كانت سلبية في مواقفها. مع ذلك، اتفق أغلب من قام بالتعليق على كتاباتي على أن الثقافة مهمة جداً في حياة كل فرد وجماعة وشعب، لأنها تلعب دوراً محورياً في تشكيل شخصية الفرد ومواقفه، والتأثير على مواقف الجماعات والشعوب فيما يتعلق بمعظم القضايا، بما في ذلك قضايا الهوية والعمل والوقت والآخر والحياة والكون.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-79-1339 |
| نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
استكشاف المسيحية الاولى
يحاول هذا الكتاب أن يجيب على أسئلة طرحتها منذ عشرة سنوات وهي: كيف كانت المسيحية في القرن الأول والثاني والثالث؟ وهل ما أسمعه من علماء الاسلام صحيح عن تغيير وتحريف الديانة المسيحية؟ وإذا كان هناك تحريف لديانة المسيح عليه السلام فهل بقية شواهد على الديانة الصحيحة للمسيح عليه السلام؟ وكيف يمكننا تمييز الحقيقة عن الهرطقة؟ وبأية مرجعية؟
الواقع وفي تلكم اللحظة لم يكن لدي أدنى شك باعتباري مسلما بل ومسلما متدينا وحافظا للقرآن الكريم حول النظرية القرآنية، وفي النقل التاريخي للقرآن باعتباره كلمة الله. لكن سرعان ما تبين لي أن هذا المعتقد إن صح في مجال الايمان الدوغمائي فهو لا يصح في المجال العلمي الموضوعي. والسبب كما وضح توماس طمسن يرجع إلى "أن افتراض أن حكايات الكتاب هي روايات للماضي يؤكد وظيفة لنصوصنا تحتاج إلى إثبات عندما تتنافس مع وظائف أخرى أكثر وضوحا"(طمسن، 2006 صفحة 11). ومعنى هذا الكلام كون نصوص القرآن لم تعد بروايتها للأحداث التاريخية الدينية منفردة بطابعها الإيماني الصرف ولكنها بدأت تزاحم مجالات اخرى وحقولا معرفية أوسع. فصارت تتخذ لنفسها وظيفة أخرى، وبالتالي فعليها أن تخضع للإثبات التاريخي للتأكد العلمي الموضوعي والمادي من المعلومات التي تبوح لنا به
إني وعلى الرغم من دراستي للكتاب المقدس –منذ سنة 1992 إلى الآن-فإني لم أقتنع يوما بالرواية القانونية عن المسيح عليه السلام. وبما أن للمسيح عيسى بن مريم مكانة خاصة في قلبي باعتباره شخصا ضحى في سبيل قضيته إلى أقصى حد وهو من أولي العزم من الرسل في الإسلام. ونظرا لكون الأسئلة تحتاج إلى أجوبة، فطبيعي أن نبحث عنها في بطون التاريخ. لا أقول التاريخ الاسلامي ولكن التاريخ المسيحي نفسه. فهو على تحيزه للمعتقد القانوني الذي اعتُمد في اوائل القرن الرابع الميلادي باعتباره تدوين المنتصرين ضد المنهزمين، فقد أبقى على شوارد واشارات أحيانا تكون قوية على الحالة اللاهوتية والليتورجية للعالم المسيحي خلال القرون الثلاثة قبله
ومن الجدير بالذكر أن قانون الايمان النيقاوي، كان ثمرة الفكر اللاهوتي الخاص بكنيسة معينة، لم تستطع حيازة الجماعة المسيحية الأولىالمتصارعة. وقد حاول الآباء الذين كتبوا باليونانية شرح وتدقيق التعابير والنقاط الحاسمة في الإنجيل، والتي قد تكون تعرضت للتحريف والفهم تحت تأثير الفكر الهلليني واليهودية المتهلنة. وفي هذا الصدد كان الوضع المركزي ليسوع المسيح"الابنالمتجسد" في ايمان الكنيسة، يتطلب الاجابة بوضوح على السؤال: عما إذا كان هو إلها أو أنه مجرد مخلوق متوسط بين الله والإنسان كسائر الأنبياء؟ واين هو الخط الفاصل بين الله والخليقة؟ وبين الله والآب ويسوع المسيح؟ أو بين يسوع المسيح ابن الله المتجسد وبين العالم؟ والظاهر من التاريخ وماجريات الصراع الطائفي الذي ألقى بظلاله على مجمع نيقية والتدخل السياسي لقسطنطين لصالح طائفة على حساب أخرى، مع ما صاحبه من الانتقائية في دعوة الأساقفة المخالفين، كلها أسئلة ألقت بظلالها على البحث التاريخي لهذه القضية، ومدى المصداقية التي اكتسبتها قرارات هذا المجمع
لقد صار للكنيسة قانونها الخاص،المستفتى عليه ديمقراطيا. وصار واضحا للكنيسة في القرن الرابع أنه فقط عن طريق فهم الإنجيل على أساس عقيدة الثالوث المقدس، نستطيع أن ندرك تعاليم إنجيل العهد الجديد المنقح عن المسيح والروح القدس. حيث كان مركز الاعتراف بالإيمان يدور حول اعلان الواحدية في ذات الجوهر بين المسيح والله لأن الله في الإنجيل قد أعلن ذاته كآب وابن وروح قدس
لقد لاقى هذا المعتقد الصاعد والذي بدى كأنه نهاية الجدل حول لاهوت المسيح والله قبولا واسعا! لكن التاريخ يقول غير ذلك. فقد اعترضت جل الطوائف المسيحية الأولى في العالم المسيحي على هذه القرارات. خصوصا طائفة آريوس وأصحابه الذين طالما اعتبروا ألوهية المسيح المساوي للآب في الجوهر والثالوث المقدس ضربا من ضروب الأساطير والعقائد الشعبية الوثنية المنتشرة في العالمالروماني آنذاك. وكانوا دائمي التشبيه لعقيدة الثالوث بالعقيدة المثرائية والهلنستية المؤلهة للبشر والرافعة للقديسين إلى مستوى الآلهة المعبودة. وقد خاضوا مع دعاة مجمع نيقية مجادلات عميقة حول لاهوت المسيح وعلاقته بالله الآب
1-أهمية موضوع الدراسة
وكما بينت آنفا، فهذا البحث ينصب على دراسة الأنماط العقائدية واللاهوتية التي سبقت ميلاد الديانة المسيحية الرسمية. وهذا أمر مهم جدا في تصوري، داخل مجال النقد الديني واللاهوتي للأديان. لأنني ومن خلال تتبعي لتاريخ الأديان عموما وتاريخ المسيحية على الخصوص، سنؤكد أو نعترض على مدى علمية وموضوعية القرآن الذي هو مرجعية أكثر من مليار وسبعمائة مليون مسلم. وكلهم يعتقدون ضياع ديانة المسيح كما نزلتمن الله. وهذا اعتقاد خطير لأنه يؤدي الى ابطال خلاص الملايين من البشر إن صحت هذه الأطروحة!! وهذا من جهة. ومن جهة ثانية: خدمة الحقيقة التاريخية، ومحاولة استكشاف اللاهوت السري للطوائف القريبة العهد من المسيح أو من تلاميذه. خصوصا وان هذه الطوائف لم تزل تشهد حملة من الاضطهاد الداخلي، وهو امتداد للعلاقة المتوترة التي كانت بين الحواريين أنفسهم حول سوء التعليم الذي قدمه بعضهم ما اعتبره البعض الآخر خروجا عن تعاليم الإنجيل
الانسان والقداسة
في ضوء فعل المحايثة ومحاولة العيش في كنف ذلك الفوقي، ومع تزايد منظومة التواصل معه، تبلور "المقدس"والذي هو وليد حتمي لطبيعة علاقة البشر مع ذلك العالم العلوي، فتم الاعتقاد أن المقدس ليس صفة ثابتة في الأشياء؛ بل تم وصفه على أنه هبة سرية تخلع على ما تستقر عليه سحرا وجلالا، فتكون النتيجة: الدّهشة والشغف والرهبة والخوف لكينونته،لهذاتم نعت المقدس على أنه قوة من العتوّ والخفاء، ولا يقبل الترويض ولا التجزئة، وفي ظل هذه المعطيات كان على الإنسان:الشعور بالرهبة اتجاهه؛ طمعا في خيره، أو خوفا من عقابه
وأقام الإنسان آلية تتولى تنظيم علاقته مع المقدس، وفي الغالب ظهرت هذه الآلية في فعل الطقوس، مع الاستناد إلى الرموز كمسلك والأسطورة كأداة، وفي ظل هذه التصورات عاش الإنسان بين عالمين، عالم المقدس الذي شعاره الرهبة والجلالة والعظمة والقداسة ؛ وآمن الإنسان القديم بأن هذا العالم المقدس يبقى مصدر كلسؤدد ونجاح وتقدم، وفي الجهة المقابلة يأتي العالم الدنيوي الواقعي العادي، لهذا آمن الإنسان القديم بتعارض المقدس مع ذلك الدنيوي، ولهذا سعى ذلك الإنسان إلى صيانة المقدس من مطامع الدنيوي، الساعي لإفساده وترويضه من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية سعى إلى الحيلولة دون احتكاك المقدس مع الدنيوي ؛ خوفا مما سيترتب من مهالك نتيجة هذا الاحتكاك
إن الرهبة والقوة والعُتوّ، ومختلف الصفات التي نُعت بها المقدس ؛ جعلته الممنهج لنمط تفكير الإنسان القديم ؛ والمُحدد لرؤيته للكون ؛ بل وجعلته المؤسس لمنظومة القيم لذلك الإنسان، فسيطر بذلك المقدس على مظاهر الحياة في شتى مجالاتها، وأصبح الشغل الشاغل لذلك الإنسان ونظرا لحتمية هذه المعطيات ؛ كان منطقيا أن تتولد منظومة من الأساطير والطقوس التي وجهها الإنسان القديم لمناشدة المقدس ومحاولة فهمه وبلورته، فنسجت الأساطير والتي كانت بمثابة النمط الفكري للإنسان القديم، وتنظيراته حول ما يدور حوله من أحداث وتطلعات، وتبلورت الطُقوس وكانت بمثابة بعده العملي، وكل هذا كان نتيجة حتمية فرضها الاعتقاد البشري حول كينونة المقدس
الديمقراطية رؤية فلسفية
لقد عادت الديمقراطية بقوتها في العصر الحديث لتحكم بها دول الغرب، كنظام سياسي يعتريه غموض غير معلن المضمون والأبعاد.. فالمعلن عنه هو إنه نظام دستوري برلماني انتخابي تعددي تداولي حر لا مركزي وغير مؤدلج، وغير المعلن هو إنه يعتمد بكل استبداد على تحكيم إرادة (الديمقراطيين) دون سواهم.. وغير المعلن أيضاً إن شعار الدمقرطة التي تبناه أولئك الديمقراطيون، ما هو إلا ذريعة لتبرير قصدية فعل العولمة في الديمقراطية، وليكون لذلك دور أكبر من دور فلاسفة اليونان وبهدف الوصول إلى أهداف ومقاصد الدراسة تم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول، ناقش الفصل الأول الديمقراطية من حيث مفهومها وأسسها ونماذجها، وقد تضمن مبحثين؛اهتم الأول بمحاولة حصر جامع ومانع لمفهوم الديمقراطية عبر استقراء الآراء المختلفة، في حين أهتم الثاني ببيان أسس ونماذجها الرئيسة ، فأسس الديمقراطية هي على وجه التحديد: الفردية والحرية والمساواة والمشاركة، أما نماذجها فقد تمحورت في: الأشكال المباشرة وغير المبشرة والنيابي أما الفصل الثاني فمثّل احتواء منهجي فلسفي تاريخي لتطور الديمقراطية في الفلسفة الغربية وفي الفكر الإسلامي، فتضمن مبحثين ؛ اختص المبحث الأول منه لتطور الديمقراطية في الفلسفة الغربية وحصر الخطوط العامة لسياق الفلسفي التاريخي في هذا المضمار، في حين اهتم المبحث الثاني منه بالفكر الإسلامي وبين مدى توافق أو تضاد الديمقراطية مع ذلك الفكر، وقدم الفصل مساهمة أساسية في عقده لمقاربة فلسفية بين تلك الفلسفة وذلك الفكر ليخرج ببناء فلسفي واضح المعالم، إذ نعتقد أن تلك المقاربة ضرورة منهجية بدونها يصبح التحليل مثلوم لقد دار الفصل الثالث في قراءة العوامل الداخلية والخارجة التي باتت تؤثر اليوم بالديمقراطية وبشكل لا يقبل الشك، لذا تموضعت مقولات معاصرة في نايا هذا الفصل، فالمبحث الأول منه ناقش الأثر من الداخل، وهو ذلك الأثر الذي يباشره المجتمع المدني، بالمقابل اهتم المبحث الثاني منه بالعولمة وأثرها من الخارج
الفلسفة الالمانية المعاصرة
الفلسفة المعاصرة بصيغة المؤنث
تأملات في الإشكالية الثقافية الثقافة والديمقراطية
فلسفة الجمال والتذوق الفني
يقدم الكتاب موجزا في تاريخ فلسفة الجمال عبر الحضارات القديمة وحتى النظريات الحديثة، مع التطرق إلى الجماليات في الفنون الجميلة بشكل عام بما فيها الأدب والموسيقى، والفنون البصرية.هذا فضلا عن إتاحة الفرص لمعرفة الحاجات والمتطلبات الإنسانية والجمالية عبر التاريخ. كما يهتم الكتاب بالتدريب على تذوق الفنون وإبراز ما فيها من قيم جمالية وتشكيلية، وعلاقتها بالزمان والمكان اللذين وجدت فيهما
ويهدف الكتاب الى اكساب خبرة معرفية في أهم نظريات علم الجمال ومفاهيمه ومعاييره والتطور التاريخي لظهورها وأسبابه، و فيما يلي اهدافه المباشرة
- التعرف إلى أهم فلاسفة علم الجمال ومواقفهم الفلسفية ما يتَّفقُ منها وما يختلف
- اكتساب خبرة معرفية في مكونات العمل الفني جمالياً ووظيفياً
- تحليل العمل الفني على اختلاف أنواعه جمالياً ووظيفياً
- التمييز بين المفاهيم الجمالية وعلاقتها ببرامج التخصص الدقيقة
- التعرف إلى منهجيات علم الجمال وطرق تطبيقها في بناء العمل الفني
- اكتساب خبرة معرفية في موضوعات علم الجمال وعلاقتها بالفرد والمجتمع والعمل الفني
- تعزيز الحس الجمالي والتذوق الفني وتطويرهما لدى المتعلم من خلال إثراء مدركاته الجمالية
- ربط مفاهيم علم الجمال في بناء العمل الفني سواء أكان تصميماً معمارياً أم جرافيكياً أم داخلياً
- ممارسة العمليات النقدية الخاضعة لمفاهيم علم الجمال في تناول الأعمال الفنية المعمارية والجرافيكية والداخلية
- التمييز بين ابعاد النظريات والمفاهيم والمعايير المختلفة الخاصة بعلم الجمال وعلاقتها بتخصص المتعلم الدقيق
- توظيف مفاهيم علم الجمال في عمليات الرسم والتصميم الخاصة بالبرامج الثلاثة، لللارتقاء بالمنتج الفني بأنواعه المختلفة شكلاً ومضموناً





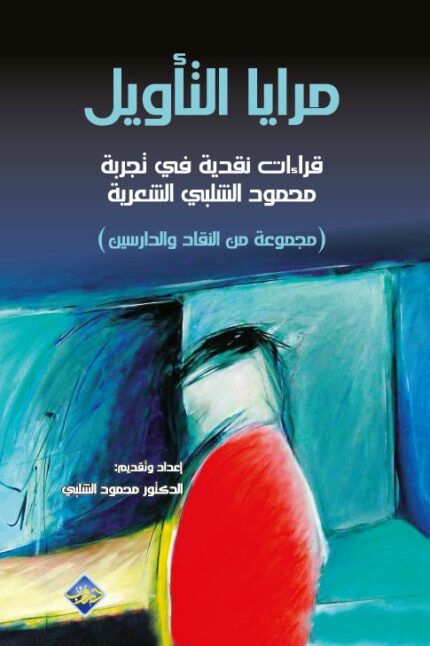
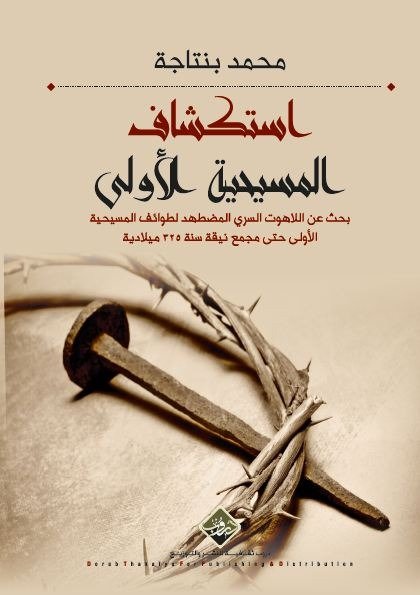



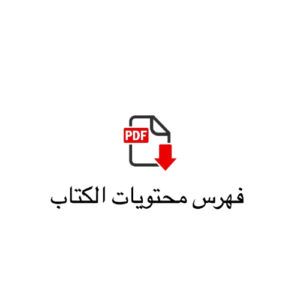
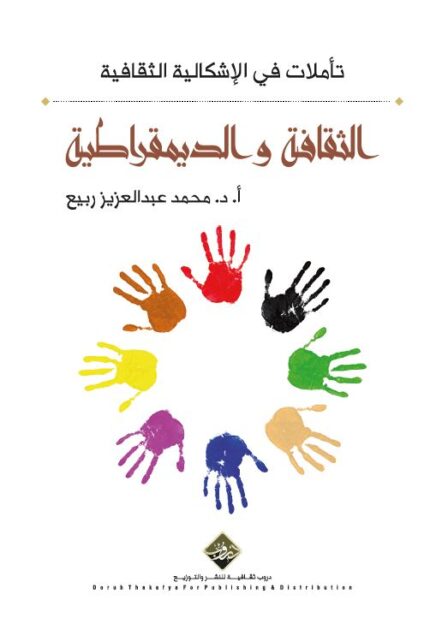


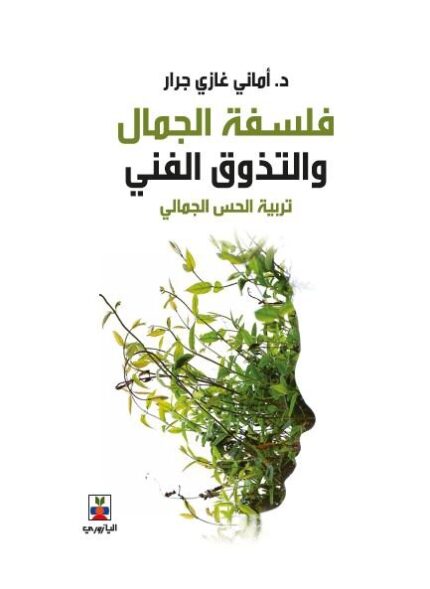
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.